رامز الحمصي
وقّع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، اليوم الخميس، على مسودة الإعلان الدستوري السوري، بعد تسلمها من لجنة الخبراء القانونيين التي عملت على صياغتها. وأعرب الشرع عن أمله في أن يكون الإعلان الدستوري السوري "بداية خير للشعب السوري في مسار البناء والتطور".
وبحسب مسودة الإعلان الدستوري، يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة، والسلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية، وتم منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ. وحددت لجنة صياغة الإعلان الدستوري أن مدة المرحلة الانتقالية ستكون خمس سنوات. إلا أن هناك العديد من الإشكاليات والتناقضات حول هذا الإعلان، وهنا نسرد أبرزها:
الإشكاليات والتناقضات الرئيسية:
1. السلطات الواسعة لرئيس الجمهورية وتعارضها مع مبدأ فصل السلطات
- المادة 13 (الباب الثالث): تمنح الرئيس صلاحيات تنفيذية واسعة، مثل تعيين الوزراء ونوابه، وقيادة الجيش، وإصدار القرارات الرئاسية.
- المادة 22 (الباب الثالث): يُخوّل الرئيس تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب، مما يُضعف استقلالية السلطة التشريعية ويُرسخ هيمنة السلطة التنفيذية.
- المادة 3 (الصفحة 9): يُعيّن الرئيس أعضاء المحكمة الدستورية العليا، مما يُهدد استقلال القضاء (المادة 24 من الباب الثالث تُنص على استقلال القضاء، لكن التعيين الرئاسي يُناقض ذلك).
- التناقض: الفصل بين السلطات (المادة 2) لا يتوافق مع تركيز الصلاحيات في يد الرئيس، مما يُشكل نظاماً رئاسياً شمولياً تحت غطاء دستوري.
2. الغموض في مصادر التشريع وحقوق الأقليات
- المادة 3 (الباب الأول): تُعرِّف الفقه الإسلامي كمصدر رئيسي للتشريع، بينما تُكرّس حرية الاعتقاد.
- الإشكالية: قد تُستخدم هذه المادة لتقييد حقوق غير المسلمين (مثل الميراث أو الأحوال الشخصية)، خاصة مع وجود بند يُلزم الدولة بمنع "الأديان السماوية" (نص غير واضح)، مما قد يُهدد الحريات الدينية.
- التناقض: يُناقض المعايير الدولية التي تُجرم التمييز الديني (مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية).
3. ضعف ضمانات العدالة الانتقالية
- المادة 68 (الباب الرابع): تُنشئ هيئة للعدالة الانتقالية، لكنها لا تُحدد آليات مستقلة لملاحقة جرائم النظام السابق، بل تترك الأمر للدولة التي قد تكون خاضعة للسلطة التنفيذية.
- المادة 69: تُجرم تمجيد نظام الأسد، لكنها لا تُوضح معايير "التمجيد"، مما قد يُستخدم لقمع المعارضة السياسية تحت ذريعة العدالة.
- الإشكالية: غياب ضمانات حقيقية لمحاكمة عادلة للمتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة مع بقاء هيكليات النظام الأمني.
4. القيود على الحريات العامة تحت مسمى "النظام العام"
- المادة 4 (الباب الثاني): تُكرّس حرية الرأي، لكنها تربطها بـ"عدم الإخلال بالنظام العام"، وهو مصطلح فضفاض قد يُستخدم لقمع المنتقدين.
- المادة 23 (الباب الثاني): تسمح للدولة بتقييد الحقوق تحت ذرائع مثل "الأمن الوطني"، مما يُشكل ثغرة لانتهاك الحريات.
- التناقض: يُناقض التزام سوريا بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي يُلزم الدول بعدم تقييد الحريات إلا في أضيق الحدود.
5. إشكالية تشكيل مجلس الشعب
- المادة 2 (الباب الثالث): يُعيّن الرئيس ثلث أعضاء المجلس، بينما يُنتخب الباقون عبر هيئات يُشرف عليها الرئيس أيضاً.
- المادة 4 (الباب الثالث): مدة ولاية المجلس 30 شهراً قابلة للتجديد، مما قد يُطيل أمد الهيمنة التنفيذية على التشريع.
- الإشكالية: غياب تمثيل حقيقي للمكونات السورية، مما يُضعف شرعية المجلس.
6. الغموض في دور الجيش والأجهزة الأمنية
- المادة 9 (الباب الأول): تُلزم الدولة ببناء جيش "وطني"، لكنها لا تُحدد آليات تفكيك الميليشيات التابعة للنظام السابق أو الفصائل المسلحة.
- المادة 8 (الباب الأول): تمنع إنشاء تشكيلات عسكرية موازية، لكنها لا تُلزم بنزع سلاح الميليشيات.
- الإشكالية: قد تبقى هياكل القمع السابقة قائمة تحت مسمى "الجيش الوطني"، مما يُهدد الانتقال الديمقراطي.
7. ضعف آليات مكافحة الفساد
- المادة 7 (الباب الأول): تُلزم الدولة بمكافحة الفساد، لكنها لا تُنشئ هيئات رقابية مستقلة (كالنيابة العامة أو هيئة النزاهة)، بل تترك الأمر للسلطة التنفيذية.
- التناقض: غياب الشفافية يُناقض مبادئ الحكم الرشيد (المذكورة في المقدمة).
8. إشكالية تعديل الدستور
- المادة 5 (الباب الرابع): يُمكن تعديل الدستور بموافقة ثلثي مجلس الشعب بناءً على اقتراح الرئيس.
- الإشكالية: يُعطي الرئيس سلطة غير مباشرة في التحكم بالتعديلات الدستورية، خاصة مع هيمنته على تشكيل المجلس.
9. التمييز ضد المرأة رغم النصوص التقدمية
- المادة 21 (الباب الثاني): تُكرّس حقوق المرأة، لكنها تكتفي بـ"حماية مكانتها الاجتماعية" دون ضمانات عملية (كالكوتا النسائية أو تجريم العنف الأسري).
- التناقض: لا تتوافق مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
10. غياب آليات حماية اللغة والثقافة الكردية
- المادة 4 (الباب الأول): تُعرِّف العربية كلغة رسمية وحيدة، دون اعتراف بلغات المكونات الأخرى (كالكردية).
- المادة 7 (الباب الأول): تُنص على حماية التنوع الثقافي، لكنها لا تُترجم ذلك إلى حقوق لغوية أو تعليمية.
- الإشكالية: يُناقض حقوق الأقليات العرقية وفقاً للمعايير الدولية.
خلاصة ذلك كله، الإعلان الدستوري يُحمل تناقضات جوهرية بين النصوص التقدمية (كالحريات وحقوق الإنسان) والبنود التي تُكرّس هيمنة السلطة التنفيذية وتُهدد الاستقلال القضائي والتشريعي. كما يفتقر إلى آليات فعلية لضمان العدالة الانتقالية وحماية الأقليات، مما يُضعف احتمالية تحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي. يُوصى بمراجعة النص لتعزيز فصل السلطات، وضمان استقلال القضاء، وإدراج ضمانات صريحة لحقوق الأقليات والمرأة، وإنشاء هيئات رقابية مستقلة.




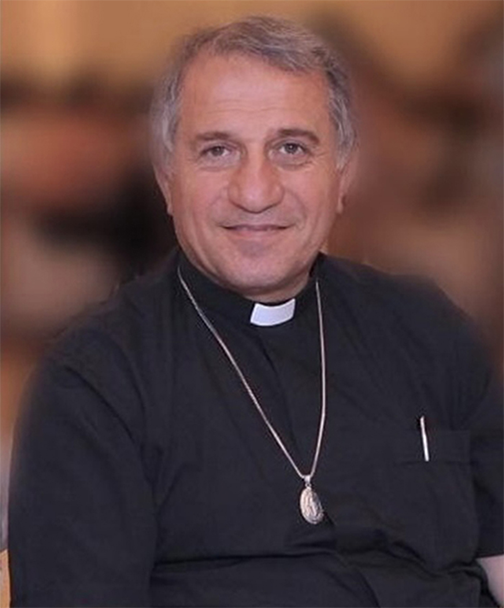






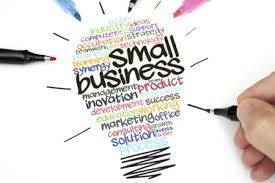

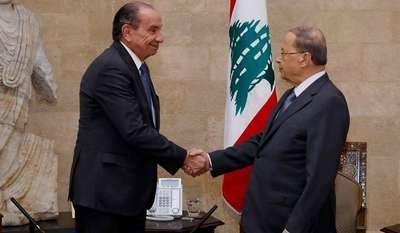

 03/14/2025 - 00:56 AM
03/14/2025 - 00:56 AM
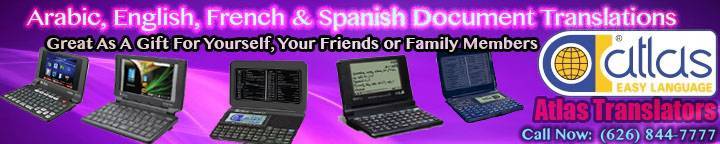




Comments