رامز الحمصي
سوريا الجديدة، التي بدأت تتشكل بعد سقوط نظام بشار الأسد، تواجه تحديًا معقدًا يتمثل في وجود المقاتلين الأجانب، ولا سيما الأويغور الذين بات حضورهم ملحوظًا في دمشق وإدلب. في حين ينظر مستقبلًا أنه ربما قد تستخدمهم دولة جارة ضد الحكومة إذا ما اختلفت معها لتنفيذ أجنداتها.
التجربة مع المقاتلين الأجانب والسلفية الجهادية في معظم الدول التي احتضنتهم كانت مكلفة على مستويات متعددة: سياسياً، حيث يُطلب ضبطهم واحتواؤهم لصالح من يخشون مشاريعهم؛ أمنياً، حيث يُطلب تحييدهم وتفكيك شبكاتهم؛ وعسكرياً، حيث يُستخدمون في معارك "ضرب الجهادي بالجهادي" لإضعاف الطرفين. هذا الواقع يضع الحكومة السورية الجديدة أمام اختبار صعب: كيف تتعامل مع هؤلاء المقاتلين دون أن يصبحوا عقبة تحول دون استعادة الاستقرار والثقة الدولية؟
يوميا ينضم مقاتلون أويغور إلى المصلين في الجامع الأموي بدمشق، في مشهد يعكس اندماجهم المتزايد منذ سقوط الأسد. يقدر قادة الأويغور عددهم بحوالي 15 ألفاً، منهم 5 آلاف مقاتل، يتركزون في إدلب وجسر الشغور، حيث أسسوا مدارس ومطاعم ومخابز تنتج خبزاً تقليدياً اكتسب شعبية محلية. هؤلاء، الذين قدموا من الصين عبر تركيا على مدى عقد، لعبوا دوراً في الإطاحة بالأسد، مكلفاً حوالي 1100 قتيل منهم، وتم دمجهم في الهيكل العسكري للحكومة المؤقتة، مع منح قادة مثل عبد العزيز داود حدابردي رتباً عالية كعميد في الجيش السوري.
لكن هذا الوجود ليس بلا تعقيدات. التجربة التاريخية تظهر أن المقاتلين الأجانب غالباً ما يصبحون عبئاً. سياسياً، يضغط المجتمع الدولي، بما في ذلك الصين والغرب، على سوريا لضمان عدم تحولها إلى قاعدة للجهاد العالمي. الحزب الإسلامي التركستاني (TIP)، الذي ينتمي إليه معظم الأويغور السوريين، مصنف كمنظمة إرهابية من قبل بكين، التي تعارض أي تخفيف للعقوبات على سوريا طالما بقي هؤلاء نشطين. أمنياً، يتطلب تحييد نفوذهم جهوداً مكثفة قد تستنزف موارد دولة ناشئة. وعسكرياً، قد تجد الحكومة نفسها مضطرة لتوظيفهم في صراعات داخلية أو إقليمية، مما يعزز الفوضى بدلاً من الاستقرار.
يقول شون روبرتس، الأستاذ في جامعة جورج واشنطن والمتخصص في دراسة السكان الأويغور، إن حدابردي انتقل إلى سوريا عام 2012، كان ذلك في وقتٍ كان فيه سيلٌ من المهاجرين الأويغور يشقّ طريقه إلى هناك، بحسب صحيفة "فورين بوليسي".
وتشير بعض التقديرات إلى أن آلاف الشباب عبروا إلى سوريا التي يسيطر عليها المعارضة، عبر تركيا المجاورة بشكل رئيسي. وقال روبرتس، الذي أجرى مقابلاتٍ مُكثّفة مع المهاجرين، إن هذا كان جزءًا من حركةٍ شُجّعت جزئيًا بموافقةٍ ضمنيةٍ من الحكومة التركية. وبذلك، كانت تركيا تُحاول التوفيق بين مصالحها: فهي تستضيف بالفعل ملايين اللاجئين السوريين، لكن الرئيس رجب طيب أردوغان سعى أيضًا إلى الحفاظ على الدعم الشعبي لقضية الأويغور لإبقاء القوميين في صفّها.
قال روبرتس: "كثيرٌ ممن انتهى بهم المطاف [في سوريا] كانوا في الأساس أشخاصًا غادروا الصين إلى تركيا. يبدو أن بعض الأشخاص داخل تركيا، وربما بعضهم بموافقة الحكومة التركية، اقترحوا عليهم الذهاب إلى سوريا، حيث سيضطرون للعمل مع هذه المجموعة، وسيتلقون تدريبًا عسكريًا، وسيتمكنون يومًا ما من العودة والقتال من أجل وطنهم، وستحظى عائلاتهم بالرعاية".
قادتهم، مثل حدابردي، يصرون على أن هدفهم ليس الجهاد العالمي، بل إيجاد موطئ قدم لقضيتهم ضد الصين. هذا يفتح الباب أمام سؤال: هل يمكن لسوريا استغلال هؤلاء كمورد بدلاً من اعتبارهم تهديداً؟ منح الجنسية لهم، كما اقترح أحمد الشرع، قد يدمجهم بشكل دائم، لكنه يثير مخاوف الدول الكبرى التي ترى فيهم خطراً محتملاً.
التكلفة السياسية قد تكون الأعلى. الغرب، الذي يتعاطف مع الأويغور بسبب انتهاكات الصين ضدهم، قد يتردد في دعم حكومة تحتضن جماعات مثل TIP، بينما الصين قد تعرقل أي تقارب دولي مع سوريا. أمنياً، تفكيك شبكاتهم ليس بالأمر السهل، خاصة مع افتقار الحكومة الجديدة للموارد. وعسكرياً، استخدامهم في صراعات داخلية قد يعيد إنتاج نموذج "الجهادي ضد الجهادي"، مما يطيل أمد النزاعات.
الحل يكمن في توازن دقيق. الحكومة السورية بحاجة إلى سياسة واضحة: إما دمج هؤلاء المقاتلين بشروط صارمة تضمن تخليهم عن أي أجندة خارجية، أو تحييدهم تدريجياً مع تقديم ضمانات للمجتمع الدولي. التجربة مع الأويغور قد تكون مكلفة، لكنها أيضاً فرصة لإثبات أن سوريا الجديدة قادرة على إدارة تنوعها وتحدياتها. الفشل في ذلك قد يجعل هؤلاء المقاتلين قنبلة موقوتة، تهدد حلم الاستقرار الذي طال انتظاره.













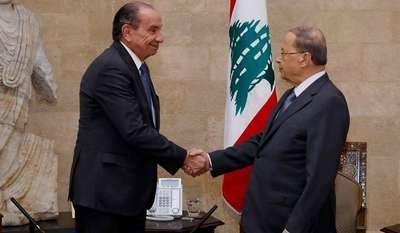

 04/06/2025 - 22:34 PM
04/06/2025 - 22:34 PM






Comments