بقلم: لبنى عويضة...
ليست مأساة أوديب مجرد حكاية أسطورية، بل مرآة قاتمة عالقة في عمق النفس البشرية، حيث يسكن السؤال الأخطر على الإطلاق: من أنا؟ وماذا لو كنت لا أعرف نفسي حقًّا؟
أوديب لم يكن طاغية، بل رجلًا شريفًا حاول أن يهرب من قدره، أن يتجنّب الجريمة… فإذا به يتّجه نحوها بقدميه.
وكم من “أوديب” معاصر بيننا: في السياسة، في التاريخ، في العائلة، في التجربة اللبنانية ذاتها.
الحقيقة كخطر: حين يصبح الجهل نعمة
لم يكن أوديب شريرًا. كل ما فعله انطلق من نية صافية: أن يتجنّب الكارثة.
هرب حين قيل له إنه سيقتل والده ويتزوج والدته، لكنّ محاولته للهرب كانت، دون أن يدري، طريقًا مباشرًا إلى النبوءة.
في لحظات كهذه، يصبح الجهل وقاية مؤقتة من الانهيار، وتبدأ المأساة الحقيقية عندما تبدأ الحقيقة بالظهور.
حين يحاول الإنسان النجاة من قدرٍ ما، يتخذ قرارات تبدو منطقية في ظاهرها: يبتعد، يهرب، يقطع صلاته.
لكنه، من حيث لا يدري، يكون يعبّد الطريق نحو ما أراد تجنّبه.
فالسعي للنجاة قد يتحوّل، حين تُخفي المعرفة أو تتشوّه، إلى آلية خفيّة لاستدعاء المأساة.
أوديب غادر كورنث ظنًّا منه أن الملك والملكة هناك هما والداه، فهرب حفاظًا على من يحب.
لكن على الطريق، قتل رجلًا لم يكن يعلم أنه والده الحقيقي.
ثم حرّر طيبة من “أبو الهول”، فكافأوه بعرشها وزواج الملكة… التي كانت والدته.
هكذا، تحقق كل ما هرب منه، خطوة بخطوة، كأن النبوءة كانت تنتظره خلف كل منعطف.
كم من خلاصٍ تحوّل إلى خراب؟
كم من محاولة “نبيلة” للخلاص في مجتمعاتنا انتهت بكارثة؟
كم من ثورة أسقطت حاكمًا لتُحكم بيد الأسوأ؟
الربيع العربي بدأ كحلم، ثم غرق في الدوامة.
وفي لبنان، كم من شخص ظن أنه تجاوز الطائفية، ليكتشف لاحقًا أنه يعيد إنتاجها؟
كم من مجموعة انطلقت بصدق، فإذا بها تُستخدم كأداة في لعبة أكبر منها، في نظام يراوغ أفضل مما يُقاتل؟
السقوط المعرفي: من الجهل إلى الانهيار
ما يسميه المسرح الإغريقي بـ”أناغنوريسس” – لحظة التحول من الجهل إلى المعرفة – هو قلب التراجيديا.
لكن في حالة أوديب، لم يكن الوعي خلاصًا، بل دمارًا.
كل ما آمن به انهار في لحظة. الحقيقة لم تُنقذه، بل قتلت فيه كل شيء.
أليس هذا ما نختبره نحن أيضًا؟
• شاب يكتشف أن عائلته التي قدّسها كانت جزءًا من منظومة فساد.
• ضحية تكتشف أن مَن أحبّته هو مَن دمّرها.
• مواطن يرى أن الرئيس الذي دافع عنه سرق منه مستقبله وكرامته.
في لحظة الحقيقة، تسقط منظومة إيمان كاملة، وتبقى النفس عارية بلا سند.
العمى كصحوة: حين لا يعود العالم جديرًا بأن يُرى
أوديب لم ينتحر. بل فقأ عينيه.
كأن الرؤية الخارجية لم تعد ممكنة.
لقد رأى بما يكفي، وقرّر أن ينظر إلى الداخل فقط.
كم منّا يعيش هذا الشكل من “العمى الواعي”؟
• من انسحب من الحياة العامة بعد صدمة عائلية أو سياسية.
• من اعتزل بعد أن اكتشف استحالة الإصلاح.
• من صمت لا يأسًا، بل لأن الحقيقة كانت أكبر من احتماله.
في لبنان، كثيرون غادروا المشهد العام، لا لأنهم انهزموا، بل لأنهم اصطدموا بما لم يكونوا مستعدين لرؤيته.
عادوا إلى العزلة لا استسلامًا، بل كمحاولة لحماية ما تبقّى من أنفسهم من الانهيار الكامل.
الذنب والبراءة: حين تكون الضحية هي الجاني
هذا جوهر التراجيديا: أوديب مذنب، لكنه لم يكن يعرف.
ارتكب الجريمة دون نية، فهل يُبرّأ؟ أم يُدان؟
هو بريء، لكنه لا يستطيع أن يسامح نفسه.
ونحن نعيش هذا التناقض يوميًا، بصيغ مختلفة:
• موظف في مؤسسة فاسدة، أقنع نفسه أنه مجرّد ترس صغير.
• ناشطة تماهت مع مشروع تغييري ثم وجدت نفسها تبرّر ما لا يُبرَّر.
• كاتب استخدمه النظام دون أن يدري.
لا أحد قصد الخراب، لكن الجميع شارك فيه بدرجات من الجهل، الصمت، أو الرغبة في النجاة.
المأساة في مجتمعاتنا لا تبدأ من شرّ صريح، بل من تراكم نوايا طيبة لم تخضع للفحص، ومن أفعال صغيرة بُنيت على جهل، فصنعت كارثة.
الهوية كفخ قاتل: من هو أبي؟ ومن أنا؟
سؤال “من أنا؟” لم يكن في حياة أوديب لحظة وعي، بل لحظة سقوط.
لأنه حين عرف، خسر كل شيء: اسمه، أصله، مكانه في العالم.
ونحن أيضًا نعيش تحت ضغط هذا السؤال:
هل أنا ابن طائفة؟ أم ابن وطن؟
امتداد لعائلة، لقب، سلالة؟ أم مشروع فرد يحاول أن يعيد خلق نفسه من الصفر؟
لكن، هل يُسمح لي أصلًا بأن أقرر من أكون؟
أم أن المجتمع قرر سلفًا اسمي، دوري، موقعي، وحتى مشاعري؟
في مجتمعات مأزومة، لا يُسمح للفرد بأن يكون ذاته.
يُطلب منه أن يُشبه الجماعة، وإلا عُدّ خائنًا، ضائعًا، مشبوهًا.
الهوية قد تكون أكثر سُمّية من الكراهية.
لأنها تُبنى على وهم جماعي، على رواية جاهزة، ونبوءات لا يُسمح لنا إلا بتكرارها.
حين لا تُراجع، تصبح مصيدة.
حين لا تُختبر، تصبح سلاحًا.
وحين تُفرض، لا تعود جسرًا للذات، بل جدارًا بينها وبين حقيقتها.
أن تسأل “من أنا؟” هو تمرّد.
وأن تصرّ على اكتشاف ذاتك خارج الرواية الجاهزة، هو معركة.
لكن من لا يطرح هذا السؤال، يعيش داخل كذبة قد لا يكتشفها أبدًا.
أوديب يسكن فينا… وفي انتكاساتنا
أوديب لم يمت.
لقد نجا من الحكاية، وانتقل إلينا.
هو في كل فرد يرى الحقيقة متأخرًا.
هو في كل مجتمع يهرب من ماضيه، فيقع فيه مجددًا.
هو في كل ثائر بدأ بصدق، ثم وقع ضحية دهاء من حوله، وتواطؤ من ظنّهم أهله.
نحن لا نُحاسب فقط على ما فعلناه، بل على ما لم نعرفه في الوقت المناسب.
وهنا تتجلّى المأساة.
ربما ليست الحقيقة دائمًا قوة، ولا المعرفة دائمًا نورًا.
أحيانًا، الحقيقة تحرق.
وأحيانًا، الجهل ليس عذرًا… لكنه الشيء الوحيد الذي يمنع النفس من الانهيار.
في زمن مثقل بالخداع، والانتماءات المشروخة، والحقائق المجتزأة،
قد لا تكون المأساة في الجريمة، بل في لحظة إدراك أننا نحن… من ارتكبناها. دون أن نعرف.
نشر في جريدة الرقيب الالكترونية













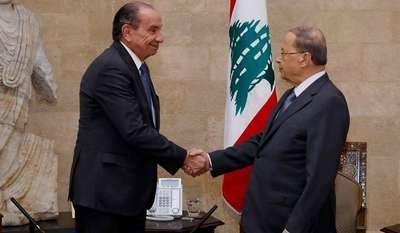

 06/30/2025 - 18:22 PM
06/30/2025 - 18:22 PM





Comments